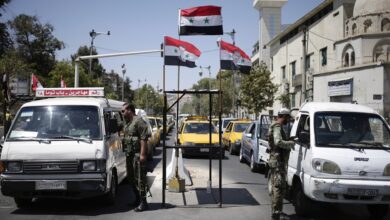دمشق – أنقرة: مصالحة أم هدنة؟

ريزان حدو
لم يكن كشف وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، عن إجرائه محادثة مع نظيره السوري فيصل المقداد على هامش اجتماعات “حركة دول عدم الانحياز” في بلغراد مفاجئًا، ولا خارجًا عن سياق تصريحات الساسة الأتراك في الفترة الأخيرة، ومنهم جاويش أوغلو نفسه الذي استبق كشفه ذلك بتصريحات تفيد باستعداد أنقرة إلى تقديم كل أشكال الدعم السياسي لدمشق في إطار محاربتها الإرهاب (إشارة تركية إلى “قوات سوريا الديمقراطية”)، وضرورة “إجراء مصالحة بين النظام السوري ومعارضيه”.
سريالية مشهد بلغراد أسّست لمشهدٍ سريالي آخر في مناطق الشمال السوري، الخاضعة للاحتلال التركي، حيث خرجت تظاهرات حاشدة شهد بعضها إحراقًا للعلم التركي، وهتافات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وإطلاق رصاص لتفريق المتظاهرين. تلت تلك الأحداث اتهامات تركية بوجود مندسين بين المتظاهرين ينفذون أجندات إرهابية أو أميركية، فحملة لاعتقال الفاعلين، وتهديد من بعض الساسة الأتراك بكسر كل يد تمتد إلى العلم التركي.
ومع أن تصريحات جاويش أوغلو أُتبعت بحملة تركية لشرحها وتوضيحها، واتهامات لبعض وسائل الاعلام باجتزائها أو سوء فهمها، لكن ذلك لم يزل شكوك كثير من المعارضين السوريين، فالحديث التركي عن ضرورة إجراء مصالحة بين دمشق والمعارضة لا يكاد يخرج عن كونه تمهيدًا لمصالحة بين العاصمتين.
لكن، هل المنشود تركيًّا مصالحة استراتيجية بالفعل؟ أم مجرد هدنة؟
يفترض منطق “الواقعية السياسية” أن المصالحة الاستراتيجية بين أنقرة ودمشق ضرورة لا بد منها، لما تنطوي عليه من مصالح مشتركة كثيرة للطرفين. فمن الزاوية التركية، يعني الأمر القضاء على، أو أقله إبعاد، “قوات سوريا الديمقراطية” ومؤسسات الادارة الذاتية عن الحدود التركية، وبالتالي منع التواصل بين الكرد في تركيا والكرد في سوريا، وشرعنة وجود نقاط مراقبة تركية في الشمال السوري عبر توقيع نسخة معدلة عن “اتفاقية أضنة 1998”. ويساهم هذا اقتصاديًا في إعادة تفعيل المعابر ونقل الصادرات التركية برًا إلى سوق الخليج العربي، فضلاً عن ضمان حصة وازنة للشركات التركية في عملية إعادة إعمار سوريا. زد على ذلك أن المصالحة مع دمشق خطوة ضرورية لترسيخ المصالحة بين تركيا من جهة ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى.
أما سوريًّا، فمثل تلك المصالحة تفترض الاستفادة من الثقل التركي، إقليميًا وعالميًا، لفك العزلة عن دمشق، وتخفيف أو خرق العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى قدرة أنقرة على تفكيك فصائل المعارضة الرافضة للمصالحة أو تحجيمها، واستنزافها في معارك خارجية أو داخلية. وقد يترافق هذا مع موجة من التصفيات لبعض الشخصيات المؤثرة، وإيقاف الدعم المالي عن الفصائل، والتضييق على مواردها الذاتية. وأخيرًا، تكتمل العملية عبر عودة دمشق لتفرض سيطرتها على الأرض بشكل متدرج بدءًا من طرق التجارة والمعابر.
في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل العوامل التركية الداخلية، وما قد تعنيه لجهة كون مواقف أنقرة الأخيرة مجرد “هدنة انتخابية تكتيكية”. في الآونة الأخيرة، تمكّن إردوغان من تحقيق بعض النجاحات الخارجية، تحديدًا في ملف الحرب الأوكرانية، وتلقّى دعمًا من جهات دولية وتمّ تصويره كرجل السلام العالمي، والمخلص الذي يسعى لإنقاذ ملايين البشر من المجاعة عبر تمرير اتفاق لنقل الحبوب الأوكرانية والروسية، وربما لاحقًا حوامل الطاقة. برغم ذلك، يدرك إردوغان أن شعبيته و شعبية حزبه قد تراجعتا بشكل ملحوظ، وأن مزاج الناخب التركي لا تؤثر فيه إنجازات خارجية، بل أمران رئيسيان داخليان: قوة الاقتصاد، والحفاظ على تفوق العنصر التركي في التركيبة الديموغرافية، وهنا تكمن أهمية إيجاد حل لملف السوريين المقيمين في تركيا.
عشرة أشهر تفصلنا عن المشهد الانتخابي التركي، وتمثّل الفرصة الأخيرة أمام إردوغان لتحقيق إنجازات تدعم حظوظه في الفوز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية (حزيران 2023) التي يخوضها باعتبارها معركة وجود، فإما فوز لـ”العدالة والتنمية” وإعادة انتخابه رئيسًا لدورة جديدة، أو هزيمة يُرجَّح أن تتبع بفتح ملفات كالتعامل مع جماعات إرهابية، ناهيك عن ملفات فساد تطال بعض أفراد عائلة إردوغان.
بطبيعة الحال، لا تغيب هذه التفاصيل عن التداول في دمشق، إذ تشير المعلومات إلى إجراء نقاشات مكثفة تدور حول وجهتي نظر، لكل منهما فريق يدافع عنها. الأولى تشجع على التعاطي الإيجابي مع الإشارات الواردة من أنقرة، بالاستناد إلى أن الرئيس التركي “رجُل صفقات”، وبالتالي لا ينبغي تضييع الفرصة أو الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، إذ إن فاز إردوغان، قد لا تظل فرصة عقد صفقة معه متاحة، لأنه سيكون وقتذاك في موقف مريح داخليًا، فضلًا عن تشدد قد يبديه للانتقام من سلبية دمشق في التعاطي معه قبيل الانتخابات. أما إذا خسر فالقادم مجهول، لكن ما هو حتمًا معلوم أن دمشق قد تكون خسرت فرصة عقد اتفاق مع شخص هو الأقدر على إدارة الانتقال التركي من مسار إلى آخر.
في المقابل، يرى فريق آخر أن الرهان على إردوغان إنما هو رهان خاسر. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى انقلاب إردوغان على مرحلة ما قبل 2011 وهو كان العصر الذهبي للعلاقات التركية – السورية، ناهيك عن عدم تنفيذه مخرجات أستانا، وسوتشي، وبالتالي فمن يضمن أنه في حال عقده صفقة مع دمشق واستثمارها في حملته الانتخابية، ألا يعود وينقلب مرة أخرى عليها؟
أضف إلى ذلك أن عقد صفقة بالصيغة المتداولة ستعني خسارة دمشق القسم الأكثر فاعلية من الحركة الكردية، وبالتالي تخليها عن واحد من أهم الأسلحة التي لطالما استثمرتها لمواجهة السياسات التركية التي تعتبرها عدائية أو غير ودّية بالمجمل (إن استثنينا ظاهر مرحلة 2003 – 2011).
وعلى ذكر الملف الكردي، يبدو أن الكرد السوريين كانوا أقله حتى الآن أوفياء للمقولة الشهيرة: “ما يكسبه الكردي في ساحات المعارك يخسره على طاولات السياسة!”. فعلى مدار أكثر من أحد عشر عامًا من عمر الأزمة السورية، لم يتمكن الساسة الكرد من ترجمة الإنجازات العسكرية، أو على الأقل تحصينها عبر اتفاقيات سياسية. وإلى الآن، لا النظام يعترف بهم سياسيًا، ولا المعارضة، ولا “التحالف الدولي”، ولا روسيا، وهذا أحد أسباب خسارة الجغرافيا في عفرين ورأس العين، مع استمرار التهديد باقتحام بقية المناطق التي لم تعُد آمنة بفعل اعتداءات الطائرات والمدفعية التركية.
لا يرى الشارع الكردي أن التصريحات التركية مفاجئة، لكن الإشارة إلى الجزائر بوصفها إحدى الدول التي تتوسط بين أنقرة ودمشق جعلت الكثير من الكرد يستذكرون بمرارة “اتفاق الجزائر” (آذار/مارس 1975) بين إيران والعراق، الذي دفع ثمنه الأكبر الكرد في إقليم كردستان العراق وقائد “ثورتهم” وقتئذ، الملا مصطفى البارزاني.
ADARPRESS #